فلسفة التسويق
ماهي عملية التسويق؟ هل هي محاولة لإيجاد شيء أو خلقه؟ قد يبدأ المسوق نشاطه للإيجاد ،لكن إن لم ينجح ينحو صوب الخلق. إن الإيجاد هو وضع يد على الموجود لكن الخلق عملية تتجاوز الواقع الموجود و تسعى إلى فتح نافذة جديدة في عقل العميل المحتمل. إنها محاولة لتلقين الحاجة فيه لجعله يشعر بأنه بحاجة إلى مايسوقه المسوق . إنه قد يشبه الشعوذة ، إنه تبرير ضرورة حصول الشخص على شيء قد لا يحتاجه من الأساس . هذا ما أصبح اليوم دارجا في الأوساط التجارية ، لكن كيف نشأت هذه العقلية و انتشرت حيث أصبحت عالمية و بديهية و دخلت حيز المسلمات المنطقية؟وهل تتمتع بمصداقية منطقية بغض النظر عن مفهوم المنطق المقبول لدى الأطراف المختلفة؟
إن عملية التسويق وفق التعريف الأعلى يجب أن تكون قد انشقت عن فلسفة الإقتصاد المعاصرة التي تولد منتجاتها وتجري فيهاكدم .تعالوا لنتأمل جذور ظواهر كهذه و أنها أين تكمن. يحتاج أي تأمل إلى نوع من الرهبنة أي الخلوة و الانكفاء الذاتي حتى في موضوعات أكثر اجتماعية. علينا معرفة كيفية معايشة الناس ومعرفة كيف يحصلون على لقمة عيشهم و كذلك الطرق المتبعة لديهم للحصول عليها. إن كسب الرزق له أسس تقليدية والإنسان إن لم يجد في الطرق التقليدية نفعا جديرا يتجه نحو الإبداع . لكن هل الابداع ينبثق من الحاجة كما يقال ؟ تعالوا نتعمق أكثر و نسبر عموديا. من أين ينبثق الحاجة ؟ أعتقد أن الكلام هو عن قاع المعرفة وأعتبر أن الملعقة لامست قاع القدر . قد يكون العلاقة علاقة عكس أي تكون قد انبثقت الحاجة من الإبداع ، أليس هذا ممكنا ؟ أليس التسويق هكذا يعمل ؟ أليس المسوق يبدع ثم يخلق الحاجة في الزبون؟ لكن ربما نحن على خطأ. ربما الحاجة كامنة فى الزبون و المسوق يأتي و يكتشفها ويريها له.
رب أنكم قد سمعتم أن الوسائل الجديدة تخلق أهدافا جديدة وليس الهدف هوالذي دائما ينتج الوسائل.
هنا يجب أن نتسائل :هل الناس يتجهون نحو القناعة أو نحو التوسع ؟ هل تحقيق الذات يتم عبر القناعة أو عبر التوسع؟ قد يختار الكثيرون الشطر الثاني . الاول يؤكد على الحذف والثاني يؤكد على الإضافة والتزود . الأول يخفف الكاهل والثاني يثقله . هل هذا صحيح ؟ لكن هل الناس يريدون إثقال كاهلهم ؟ قد يستنبط البعض من الأول التخلف و الجمود ومن الثاني التقدم والصعود . يبدوا أنني ألعب بالألفاظ و أدور حولي و لم أخرج من السؤال إلى الإجابة بعد . لكن دعونا نستخدم ألفاظ عدة ونقلب الموضوع من وجوهه المختلفة ، كلنا نتلاعب بالألفاظ ألسنا كذلك ؟ هذا ليس سمة سلبية إذ هكذا تلاعب قد يصل بنا إلى أمور جديدة و يفتح لنا آفاق غير متوقعة ،على كل نحن الأفضل بكثيرمن لاعبي كرة القدم أو أي كرة أخرى لا سيما لاعبي الكرة الأرضية ، هم الذين يستحقون كل عتاب و الاتصاف بالسمات السلبية ،نحن نريد الكشف وهم يريدون الاستخدام ثم الاستهلاك ثم الغلبة ثم الاستبداد و من ثم يتوسعون في تلك الشبكة الرديئة و بعد قرن من الزمان تجدهم في زبالة التاريخ. قد يقول القائل ما هو النتيجة بعد كل هذا ، تلف بنا و تدور ولا تقدم لنا شيئا . حسنا لكننا لسنا في عجلة من أمرنا ،لماذا العجلة والتسرع؟ كلنا أصبحنا مستعجلين في العصر الحديث حتى المسوق ، بالمناسبة كلنا أصبحنا مسوقين أيضا . نسوق شيئا لأجل الحصول على شيئ آخر . يارجل ،ألا تعرف أن هذه السببية المتسلطة علينا قد نفيت منطقيا من قبل الفلاسفة و الفيزيائيين الكبار .فقدنا ممارسة شئ لأجله ؛لذاته . حقا قد فقدنا هذا الشعور.
إن التسرع ناجم عن المنافسة ؛المنافسة الضارية القائمة في السوق . المنافسة هي التي تشكل عصبة الاقتصاد اليوم. يقال بأن المنافسة هي محاولة لإنتاج الأفضل. لكن هل هوكذلك فعلا؟ قارنوا منتجات الماضية بالحاضرة ، هل ترون ذلك؟ إننا لا نركز على عملنا وإنما نركز على بعضنا البعض .إن علاقاتنا التنافسية أصبحت ترشد عملنا وتحدد ما هو علينا صنعه. لكن ما هو حقيقةالتنافس؟ تعال لنشاهد التنافس لنعرف ما هو أساسا؟ نعم المشاهدة وليست الدراسة . التنافس هوالغلبة والسيطرة على الآخر ؛على الآخرين؛على الجميع. لقد أبدعوا أخيرا مصطلح "التنافس الشريف" إنه سخرية من أنواع المساخر التجارية الكثيرة التي يقدمها التجار لتنظيف التنافس من أدرانها ، لتنظيف ما هو يتشكل من الادران ذاتها . إنهم يسخرون بأنفسهم قبل أي شخص آخر .إن المنافسة منازعة لأجل البقاء على حساب الآخر . إن هذا البقاء ليس على الحياة و انما البقاء على كيفية من الحياة . لكن لماذا لا نشتغل على أساس المساهمة . إن المنافسة لفظة سلبية وإن المساهمة إيجابية . إن المنافسة تدل على طرد الآخرين من الميدان بينما المساهمة تدل على إشراك الآخرين في الميدان.نعم وضعوا حدودا في القانون لتصبح المنافسة شريفة ،هناك قوانين تكافح التراست لكن هل يشعر احد الآن بأن المنافسة اصبحت شريفة .إن المنافسة ستصبح شريفة عندما يصبح عمل اللص شريفا. إنه يجرنا الى مناقشة مصطلح الشرافة .
هناك تعقيدات في تربية الانسان ، نحن من الصغر تربينا على اساس المنافسة فالمنافسة أصبحت من البديهيات الحياتية بحيث نشاهد الحياة من منظار المنافسة . والمساهمة هي من الكماليات والفضائل . نحن نحب المساهمة لكن اللحمة والسدى لجسدنا و فكرنا تشكلت من المنافسة ،فإما أن نكمل مانحن عليه أو نتطلع إلى اسلوب آخر والآخر طبعا هو المساهمة.
المنافسة تنجم عن المقايسة أي القياس ، فتقيس شيئا على آخر إذن هناك شيئان اثنان. لكن أيهما هو المعيار ؟ إن القياس قد ظهر في العلوم وأدى إلى تقدمها الباهر .لقد اتفقوا على شئ كمعيار ؛ إنه مجرد اتفاق و مصالحة اجتماعية . لكن ألا يجد للقياس جذوره في عمق وجدان الفرد ، أو هو عبارة عن انطباع اجتماعي سطحي عابر . ألا ينبع هذا السطح عن حالة الانسان الجوانية ؟ نريد البحث عن مركز و منبع القياس . يبدوا أن القياس هو بدوره أيضا مظهر من مظاهر شئ ما. لكن ماهو؟ ربما الشعور للأفضلية أي أن تكون أفضل من الآخر . أو ربما الفضول لمعرفة موقعنا بين الآخرين . لكن ألا يرجع هذا الأخير إلى الأول. إذ بعد معرفة موقعنا نريد أن نعرف هل نحن الأفضل أو الأردأ؟بإمكان الانسان أن يتمتع بشعور التنوعية بدل التفاضلية . إن التنوعية لهي قاعدة المساهمة .لكن لماذا رسخت التفاضلية في ذات الانسان، نجد أن التعاليم الخالية كالأساطير والأديان ترتكز على التفاضلية ؛ الإله والانسان والخير والشر والملك و الشيطان . ربما الشعور ذلك وهذه الخلفية قد أوجدت كل هذا. لكن كيف وقعنا في هذا المستنقع؟ لا بل الأحرى علينا أن نتسائل كيف أصبحت ذواتنا مستنقعات؟ إننا المستنقع و لا أحد قادر على انقاذنا من الخارج إذ لا أحد في الخارج أصلا ؛ نحن الداخل و الباطن والمستنقع فينا وصل إلى حناجرنا و حبال الانقاذ بأيدينا فلماذا لانقدم لفعل ما ،ننتظر ماذا؟ حسنا أظن أننا لانعرف أننا المستنقع بل نظن أننا في المستنقع فننتظر النجدة من الخارج؛ هذا هو الخطأ الفادح. تصورالوضع بهذا الشكل أسهل إذ إنقاذنا من قبل الآخرين لا يحتاج إلى عناءنا لكن إنقاذنا من أنفسنا وبنا يحتاج إلى كبير عناء . دائما نريد أن نحصل و لا نريد أن نعطي و نقدم ،الإنقاص من الآخرين والإضافة إلينا . هذا هو فلسفة الحياة اليومية المعاصرة حتى في أشد الحالات خطورة علينا. قد تنبعث التفاضلية من الديالكتيك القائم بين المجتمع والانسان ، المجتمع المتفاضل ينجب الانسان المتفاضل لكن هذا ليس كل شئ ،إنه تحليل سطحي. إن معرفة الانسان مستوردة من خارجه ، أجل ولكن نحن نتسائل عن المنشأ والمصدر الأخير ، عن النقطة التي حدثت فيها هذه الكارثة .كارثة التفاضل . لنرجع أدراجنا صوب الانسان البدائي ،هل عقليتهم كانت تفاضلية أو تساهمية ؟ لننظر الى الأنواع الأخرى كالنحل والنمل وغيرهما كالنمور والفيل والنسوروغير ذلك. إن التفاضلية أوالتساهمية تنجم عن طريقة حياتنا وطريقة حياتنا هي من إنتاج طريقة تفكيرنا والأخير هو مدفوعة إلى اتجاه معين عبر مشاعرنا والتفاضلية هي شعور ،نعم قدرجعنا غلى ما بدأنا به ، إلى دور . يبدوا إيجاد أساس معقول للتفاضلية صعب جدا.
لندخل في مناقشة مفهوم الهدف ، ربما نجد مخرجا فيها . ما هو الهدف ؟ إن الهدف هو أمر مستقبلي ، إنه واقع أمامنا هناك مكانيا وأوزمانيا ونحن نبذل جهدنا لنصل إلى هناك. إننا هنا ولكن تصورنا هناك و نشد أنفسنا لنصل إليه. لا يهمنا هنا هل هذا الشد متصل أو منفصل متقطع . إن مايهمنا هو أننا نتصرف الآن حسب ما نتوقعه في المستقبل . يبدوا أن المستقبل هو الذي يدفعنا . إن الماضي بكل مكنوناته فينا يدفعنا و المستقبل بكل آماله يشدنا وبهذا تتم وتتكون الحركة ، أي حركة الحاضر من الماضي إلى المستقبل. فإذا أردنا الوصول إلى نقطة ما فعلينا إبعاد النقاط الأخرى أي العراقيل أو الموانع الموجودة في سبيلها . إن النقطة المحددة هي أنا ومتعلقاتي والنقاط الأخرى هي الآخرين و مايتعلق بهم . يبدوا أن التفاضلية قد انبثقت من هذه الفكرة ، أي فكرة الهدف ، الهدف المحدد ، الانتصار. التفاضلية هي الانتصار على الآخر والتساهمية هي نصرة الآخرين ؛ نصرة الآخرين فقط ولا يتخطى هذا الى نصرة الآخرين على الآخرين بل يتوقف في الشطر الأول.يبحث المرء في التفاضلية عن فضله على الآخرين والتساهمية يبحث عن سهمه مع الآخرين. إن التفاضل نهر يجري بقساوة ويقلع كل ما يقع في طريقه و يشق مجراه دون أن يراعي الحقول والطرق والأشجار ولايقف حتى يصل النقطة ،اللهم إلا إذا طرأ أمامه أقوى و أكبر منه.والتساهم كنهر يجري بلطافة ومرونة بين الأشجار والحقول والطرق و هو أيضا لا يقف ولكن لا ينتظر نقطة ما و لو لم يطرأ أمامه من متفاضل أقوى منه يجري الى لانهاية . إن المتفاضل له نهاية والمتساهم ليس له نهاية ؛إنه الأبدية وهكذا تتحقق الأبدية في الانسان ولو درستم أحوال كل من أصبح خالدا لتجدون الأبدية فيهم؛ هذا هو سر الخلود.
إن الموضوع التذي نناقشه يمت بصلة لفلسفة الاستهلاك و مايقابلها الإنتاج . إنهما حالة طبيعية موجودة في الانسان وفي المجتمع البشري لكن أيهما المحور و الأساس أو بتعبير أدق من أيهما ينظر الانسان الى نفسه و الى العام ، أيبدأ الانسان من الذات أم من الموضوع؟ إن الانتاج يبدأ من الذات ،والاستهلاك من الموضوع وهذا قد يرادف المثل الفلسفي المعروف مايقول هل الانسان يأكل ليعيش أو يعيش ليأكل؟ قد ينتقدنا أحد بأن الإنتاج والاستهلاك وجهان لعملة واحدة إذ من ينتج يستهلك و كل عملية استهلاك مسبوقة بالإنتاج. إن هذا التنظير ينبعث من رؤية عددية ، كمية منطقية سطحية للمشاكل . إننا لانشاطره الرأي ، إذ القصد من الإنتاج هنا هو الانتاج بمعناه الابداعي والاستهلاك بمعناه الكيفي . ليس الانتاج هنا أن تبدع شيئا و تنسخ منه آلاف النسخ بل أن تبدع شيئا ثم شئيا بديعا مختلفا آخر. والاستهلاك ليس أن تكثر أو تقل من استعمال الشيء المعني بل أن تكيفه، أي الأمر يتعلق بكيف تستهلك فمثلا إن الاسراف لا يعني قلة الاستعمال وإنما تحسين طريقة الاستعمال أي الاستعمال والاستخدام الصحيح المسألة هي أن تنتج أفضل شيء لتستهلك أحسن لا أن تتزايد عدد الانتاج لتستهلك أكثر( صرفه جويي كم مصرف كردن نيست بلكه درست مصرف كردن است). إن من ينظر من نظارة الاستهلاك الكمي يسعى الى استهلاك أكثر و هذا يؤدي الى اناتاج أكثر ومن ينظر من منظار الانتاج الابداعي يسعى إلى إنتاج أفضل لاستهلاك أحسن و أوفر . إن المبدع يريد أن يساهم في إضافة الجديد و المستهلك الكمي يريد أن ينافس في أخذ الكثير خلافا للمستهلك الكيفي الذي ينحوا نحو استهلاك أحسن. إن المستهلك الكمي يأكل أكثر ما يمكن فيطالب بإنتاج أكثر و المنتج الإبداعي يحاول إنتاج الأفضل ليستهلك الأحسن . طبعا في الأولى يكون التركيز على الكثرة والردائة و في الثانية يكون على القلة و الجودة. هناك طعام كثير لا خواص له و هناك طعام قليل مليئ بالخواص. إن من يفكر جيدا لا يحتاج إلى أن يفكر كثيرا .الكلام هو على كيفية التفكير و ليس كميته و الجودة في الكيفية تغني عن الكثرة في الكمية . فالسعي للحصول على الأكثر هو قانون النظرة الاستهلاكية التي تشجع التفاضلية والسعي لإبداع الأفضل لهو نلاموس النظرة الإبداعية . هناك من ينشد العطاء و هناك من يبتغي الألأخذ . إن العالم الآن أصبح مبنيا علىثقافة الأخذ؛ثقأفة من يأخذ أكثر؛ثقافة الأخاذين . طبعا هناك عطاء لكنه قليل و أكثره عطاء تافه الذي انبعث من الاستهلاكية ، عطاء لا يعطي حقا وبمعنى الكلمة عطاء هش تذريه نسمة بسيطة. فهناك سجال و سباق بين المتفاضلين للحصول على الأكثر وليس الأجود . وهذا ما يؤدي إلى النزاع و الخصام كالذئاب التي تجتمع حول الوليمة والمصيد والأقوى يحصل علىالأكثر بعد النزاع و هذا هو فلسفة نشوب الحروب.
لقد تكلمنا عن الهدف باسهاب والآن نسلط الضوء على بعد آخر منه . إن الانسان كفرد له ماضيه والانسان كمجتمع له ماضيه كذلك. إن الماضي والغابر هذا ،هو المسؤول عن تحديد مسار الحاضرنحو المستقبل إن الماضي هو تراك معلوماتي ترسخ في وجداننا ،وإرادتنا الحالية تنبثق من الغابر المشحون بالمعلومات والتي تزودناها حتى لحظة الآن . تفاعل الكم المعلوماتي والنفسي الماضي تحدد إرادتنا وهدفنا ورغبتنا الحالية . يبدو أن هذا الكائن ليس حرا وقد لايستطيع أن يتخلص من الماضي لكي يتحرر. إن المعلومات الوافدة من الخارج ، من البيئة ،من المجتمع والأسرة والمدرسة . لكن هل هناك جزء ليس بخارجي فينا؟ هل بإمكاننا إزالة كل ما هو خارجي لنصل الى ما هو أنا الخالص؟ ‘إن المجتمع كأفارد يقوده ماضيه ، الكم المعلوماتي والنفسي والحضاري الذي سبقه يدفعه تحت إطار صنعه ماضيه . ومن الصعب لهم أن يتحرروا من ماضيهم المشرق أو الردئ. لقد ثبت أن الحضارات المشرقة ظهرت في الشعوب التي لم يكن لها ماضيا مشرقا. يبدو أن المعلومات المتراكمة في وجدان الحضارات المشرقة تمنعها من إنتاج الحضارة بشكل متواصل و تعيد و تكرر إنتاج نفسها وتدخل في دور ، إذتقع في شراك و فخ مفاخرها الغابرة . بالعكس أن الشعوب التي ليست مشرقة يشعرون بالنقص و يأملون لو كان لديهم أيضا مايجعلهم مشرقا فلذا يبذلون جهدا دؤوبا للوصول إلى شيء أو إبداع شيء ما، كي يأخذوا دورا ملفتا بين الأخرين إن الحضارات تتطور وفي نقطة ما تبدأفي الزوال .إن الحضارة تؤسس مبادئ بنيوية التي ترفعها نحو الأعلى لكن هذه المبادئ تعجز عن الإنتاج عندما تصل الحضارة إلى حد معين . في هذا الحد المعين تحتاج الحضارة إلى تغيير مبادئها و مسالكها البنيوية وهذا ليس بأمر سهل فلذا تنحدر نحو الأسفل إذ أنها لا تستطيع تغيير نفسها وفق المعطيات الجديدة وتحاول الاستمرار عبر المبادئ الماضية . والانسان على مستوى الفرد لا يختلف أمره عن الانسان كمجتمع وهو أيضا يحتاج الى إعادة النظر في معتقداته البنيوية بعد فترة .ومن الأفضل أن يكون معتقداته في فحص بنيوي دائم . إن الماضي يدفع من الوراء ويخلق أيضا فخا في الأمام المسمى بالهدف فهو يرهقنا عن جهتين . علينا أن نجد تسمية أخرى للماضي إذ أنه موجود في الخلف و كذلك في الأمام . نحن سميناه الماضي زمنيا لكنه يؤثر فينا عمليا في الحال والمستقبل.
نحن لا نبحث عن نفس عارية وإنما عن نفس حذرة ومنتبهة . إن الحياة مليئة بالتجارب وتتخزن تجارب الأشخاص في وجدانهم . إن التجربة بحرفيتها لاتفيدنا شيئا إذ التجربة التي حصلت في الماضي قد لا يتكرر.إن فائدة التجربة ليست فقط فيما تعلمه من معلومة للشخص بل التجربة تعلم اليقظة . إن التجارب التي لا تؤدي هذا الدور تبقى على مستوى معلومة والمعلومة مفعولها محدود لكن اليقظة لهي شعور دائم ويحملها الشخص في كل مجالات حياته و بهذا التجربة تتسع وتصبح غير محدودة . إن التجربة لا تقدم فقط المعلومة وليست أهميتها في المعلومة التي تقدمها بل في الطاقة التي تصل عبر المعلومة هذه إلى الضمير وبهذه الطاقة يبقى الضمير حيا وقادرا علىالإنتاج إذ الانتاج يحتاج الى طاقة و الانتاج الأبدي يحتاج إلى طاقة أبدية لذا نجد أن أعمال الكبار تبقى علىمرالعصور . إذ أنها مزودة بطاقة أبدية . التجربة ، الماضي والغبر يجب أن تؤدي دورا كهذا فينا. يجب أن نتزود بطاقات عن الماضي وليس المعلومات فحسب. وهذا يتوقف على السؤال الآتي : هل أننا نريد الأبدية ؟
إن الطاقة هذه تشبه الطاقة التي نجدها عندما نسمع مقطوعة موسيقية كلاسيكية ،مقطوعة تشع طاقة وتصل الضمير و تشعله. إن الطاقة اليست بيانيا و لفظيا بل إنها عنصر شعوري يستحيل التعبير عنها في المفردات مع أننا نحاول تعبيرها عبر المفردات لكنها تبقى المفردات عاجزة عن التعبير التام.
إن كل ماجربناه وتعلمناه في الصغر عن العائلة والمدرسة لم تبقى فينا كمعلومات فقط وإنما كطاقات فينا قد تكون سلبية أو ايجابية . نحن لانتذكرغالب ما تعلمناه في الصغر والماضي كمعلومات وإنما كتأثيرات ومن حيث لا ندري . إن الانسان كل ليس له سابق وآتي من حيث الكيان إذ السابق وما ينتج منه الآتي بكل ما فيهما ينصبان في الكيان الانساني اللامتجزأ ويشكلان شخصيته. إننا عندما نتعلم لغة ما ونصل الى حد الاتقان . هذا الاتقان ليس حصيلة لحظة الآن ولاندري في أية نقطة من مسيرة التعلم وصلنا الى حد الالتقان بل اللغة المتقنة هذه هي السابق والحاضر المصبوبة فينا. إن إتقان اللغة في لحظة الآن هو حصيلة مسيرة التعلم . كلها قد ننفصل ونمرحل المسيرة هذه لكننا لا نستطيع تجزئة الاتقان.الاتقان مهارة والمهارة غير قابل للتجزئة . المهارة ليست تجمع الجزئيات المعلوماتية فوق أو جنب بعض وإنما حالة غير قابلة للتفكك. كل معلومة نكسبها تتحول الى قابلية ألى طاقة التي هي المهارة والمعلومات الأخرى بعد الأولى تصب طاقتها في الطاقة الاولى وهذه الطاقات لا تتجمع رياضيا جنب بعض بل تتجمع قوة واحدة كالقطرات التي تتوحد.
المعرفة للمعرفة-المعرفة للمصلحة
لقد شاعت اليوم ثنائية المعرفة للمصلحة بعد أن كانت امعرفة لذاتها. لسنا بصدد مناقشة آليات المعرفة أي كيف يتم المعرفة وإنما نريد أن نعلم لماذا نعرف. في المعرفة للمعرفة نحن نعرف لكي نعرف. ليس الهدف من المعرفة هو أن نعثر علىمعلومة فحسب بل لنصل الىتكوين آخر ،إلى حالة روحية أخرى الى درك و فهم جديد عن أنفسنا وعن العالم حولناز لسنا بصدد جمع المعلومات ،إن المعلومات الوافدة من الخارج تتحول الىطاقة منعشة في باطننا والمعلومات تتبعثر في الأخير وتبقى الطاقة .في المعرفة للمعرفة لا يهمنا المعلومة من حيث أنها معلومة وإنما الحالة التي تترك المعلومة المعرفية فينا.المعلومات التي لا تترك بصماتها في الضمير ليست إلا معلومات رديئة وخير للأنسان أن يستغني عنها. قد تأتي المعرفة بالمصلحة ورائها لكن في البداية يجب أن يتم المعرفة . ولا مصلحة من دون المعرفة.إن المصالح تحتاج إلى معلومات عدة والأخيرة تحتاج الى معرفة واحدة حية متخلخلة كالروح في جميع المعلومات المتناثرة ولتربطها بعضها ببعض كجسد واحد.يجب أن يكون هناك معرفة لكي نقدر على تشكيل عناصر سلتنا المعلوماتية بالشكل الذي تستوجبه المعرفة. مثل الولد الذي يبني من أحجار لعبته شكلا معينا وفق ما أوحت إلى معرفته. المعرفة للمصلحة تنتهي إلى التخصص ونقوم بتنقية المعلومات التي تنجز مصحلة ما. هناك نوع من التركيز البالغ على قسم من العلم هناك نوع من فك عرى العلم وقلع المعلومة من سياقه. مع الأسف يبدأ التخصص قبل أن تتحقق المعرفة الكليانية. يبدأ المتخصص باللغب على جزء قبل أن يتمتع بالإطلالة الكلية . ومتخصص آخر يفعل مايفعله بالجزء الآخر دون علمه بزميله حق علم . الكل يتصرف وفق ما يقتضي الجزء الذي يعنيه. وبهذا تبقى العلوم المتناثرة متناثرة واللوحة تفقد جمالها؛إنها لوحة الحياة . الفرد يعتقد أنه أدى واجبه ولايقول أننا كأفراد جميعا أدينا واجبنا.
لا نستطيع تعلم كل شيء بالتفصيل لكن هناك معلومات أساسية و بنيويةالتي تصوغ هيكليةالعلم وبالتالي المعرفة ، أقثد بالمعرفة هنا الفلسفة المستنبطة من العلم كما قصدتها سابقا مرات عدة . هناك كم هائل من المعلومات الهشة وغير مرغوب فيها . إن الكتب المنتشرة بغض النظر عن مؤلفها لا تستحق عناء قراءتها . لكن هشاشة و عدم جدوى هذه المعلومات لاتنبثق من ذاتها وإنما من سياقها الخطأ الذي وضعت فيه هذه المعلومات.إذلايمكن أو من الصعب الاعتقاد بوجود معلومات غير مفيدة او أن نقول أنه توجد معلومات ليست معلومات فعلا.
لو بحثنا في عالم الروايات نجد أن الروايات التي تستحق قرائتنا قليلة . لكن الباقية لماذا ألفت؟ هل كانت ابتغاء للمال ؟ أو مؤلفوهم كانوا على ايمان بأنها تستحق الكتابة لكن الحظ لم يرافقهم؟ أعتقد أنالعمل الجدير سيجد مكانته عاجلا أو آجلا.
هناك معادلات لا تعد ولا تحصى ، حاضرة في الوسط الفيزيائي . لكن الرواي كزميل للفيزيائي لا يتوغل في الفيزياء كمايفعله الفيزيائي هناك نظريات ومعادلات معدودة التي تشكل هيكلة الفيزياء فعلى الراوي معرفتها وهكذا الرواي يفعل المثل تجاه كل الاقسام العلمية ويحصل أخيرا على الاطلالة.
عندما يشتاق المرء الى معرفة ما لاجلها ،يود العم بها من كل جوانبها ويبتغي معرفة غير محدودة ويتوغل ثم يتوغل ولا يشبع مثل من يشم رائحة طيبة ويتبعها ولايدري الى اين سوف تصل به.
عليك أن تشتاق لتدرك وتستوعب فهناك دفعة الشوق والتشوق وهذا ما ينبثق من الداخل ، من حيز نعجز عن تعريفه. لكن في حالة المعرفة للمصلحة ، المعرفة تتخذ مسارا معينا و يختصر المتعلم على معلومات معينة غاية الوصول الى شيء معين . إنه يطلب معرفة محدودة ، والمعرفة بذاتها ليست مطلوبة.لا أقصد من لفظ محدودية واللامحدودية محدودية المعلومات او عدمها وإنما الآثار والافق الذي تفتح هذه المعلومات . إن الأول يبتغي المعلومات المحدودة والثاني المعرفة اللامحدودة.
سجال كيفي و كمي في الجمال
هناك مباريات عدة في العالم ؛ مباريات كيفية أي جمالية ومباريات كمية أي بعدية. في الاولى توجد هارمونية في المكان والزمان وفي الثانية يوجد قطع المكان والزمان. الاولى تهتم بالجودة الثانية تهتم بالمسافة . في الأولى يحاول المرء تحويل المكان والزمان الى ما هو ليس بمكان وزمان وفي الثانية يبقى المرء فيما كان فيه بل ليس هذا فقط وإنما يحاول تحويل كل شيء الى زمكان ألى مسافة . المثال الأوضح لما قلنا هو سجال الفنانين ، الاول يرسم في حيز محدود و يحاول أن يرسم ما هو فائق لاجمال والثاني يرسم في حيز ذي حدود شاسعة و يحاول أي يرسم رسما طويلا فقط . لننظر إلى مباريات كرة القدم أو العدو ، كل يريد أن يغلب على الآخر في المسافة أو عدد الأهداف فهناك عدد وكمية . لاريب أن من الممكن ممارسة العدو و كرة القدم بطريقة كيفية جمالية فردية وهذا يحصل عندما الفرد يعدولأجل العدو ويتلاعب بالكرة لايجاد حركات فردية جميلة أو جماعية مشاركة .انظروا الى رياضة السباحة عندما يخرج السابح من إطار و جو المسابقات كي يسبح ويؤانس بالماء ويعلب بالماء ويغوص ويطفو لأجل احداث وايجاد حركات موزونة وليس لأجل قطع مسافة أطول للغلبة على الآخر. فكل رياضة أو ممارسة فيها القابلية لتتحول الى الكيفية أو الكمية بيد الذات الفاعلة . كمن يقرأ الكتاب ليفهم ما كتب فيه و لو سطرا واحدا ومن يقرأ الكتاب لينتهي منه وليس الفهم أي استيعاب حجمي بلا دراية و تعمق . وهنا يتميز الانسان السطحي و المتعمق فأنتم إلى أيهما تنتمون؟ انتبهوا بأن في الأولى يتم دمج في الزمكان مالا يحصل في الثانية.فآمنوا بمباريات الرقص وليس النصر.
التفكير العميق والتفكيرالسريع
هناك طريقتان في لعبة شطرنج ، بطيئة و سريعة كما تعرفون . وهناك نوعان من الاشخاص في طريقة تفكيرهم ، واحد يحتاج الى وقفة طويلة في اتخاذ القرار والآخر يتخذه بعد تفكير وجيز . الاول يدرس الموضوع ضمن سياقه العام والثاني يدرسه ضمن سياقه الخاص. التفكير العميق يحتاج الى جهد بالغ في التفكير نفسه والتفكير السريع لا يحتاج الى كبير عناء إذ يهتم بالمواضيع . الاول يطغى عليه التجريد والثاني تطغى عليه الأمثلة والأعيان . المفكر العميق هو مثالي والمفكر السريع هو واقعي . الأول منكفئ على ذاته والثاني موجود اجتماعي. إذ اتعمق يحتاج الى الخلوة. المفكر العميق يحاول لم شتات السطوح وبطها ببعضها بقاعدة واحدة ما يجعل الشتات المتناثرة منسجمة وذات معنى ويجمع القواعد للوصول الى أصل واحد وهكذا دواليك يتوغل نحوالاعماق.
الرؤية العلمية والرؤية الكشفية
الخلاف بين الرؤية العلمية وبين الرؤية الحدسية الكشفية (الموسيقية ) هو أن الاولى مبنية على المنطق والثانية مبنية على التبصر والشعور . الاول يحاول تعريف ظاهرة كالألم عبر سرد تسلسل منطقي لعلل الألم كإفراز الهومونات والتقلبات الجسدية التي تطرء على الجسد في حالات خاصة ،لكن الثاني يدرك الالم مباشرة . الاول يحاول معرفة الالم ويحرز ماذا عسى أن يكون الألم ويتعرف عليه عبر الظواهر المادية الجسدية والثاني يشعرها . الاول ممكن التعليم والثاني مستحيل التعليم قد يرشد اليه لكنه لايمكنه أن يلقن الالم الذي شعره بطريقة منطقية . لنحاول شرح كلمة لطيف عبر سلوك ما ، نعين شخصا عجوزا أوضريرا في قطع شارع ونسمى السلوك هذا لطيفا هل الآخر كطالب يستطيع التذوق باللطف ،قد يفهم السلوك كسلوك خير لكن تذوق اللطف الموجود كالملح فيه هو المهم . نستدل بأنه خير بطريقة منطقية لكن هنا يوجد فصل بين الذات والموضوع ولن يتوحدا إلا حين يتم تذوق اللطف حين يستغرق الذات في الموضوع.
من يفكر جيدا لا يحتاج إلى كثير تفكير.
ما يدل على جودة التفكير وليس كمية التفكير مثل من يحاول حل مسألة رياضية وهو بارع في الرياضيات فيحلها بتفكير وجيز مقارنة بمن ليس بارعا فإنه لو فكر كثيرا لن يستطيع حلها أوقد يحلها بصعوبة .
جمال
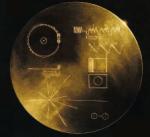 جذبه های کوچک میتوانند به افکاری بزرگ منجر شوند
جذبه های کوچک میتوانند به افکاری بزرگ منجر شوند